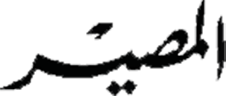مقاربات حول الدولة المدنية في تونس عن الثورة التونسية وشروط قيام الدولة المدنية عربيا
1 min read
د. توفيق المديني
منذ دخول “ربيع الثورات العربية” عامه الثاني، مجسداً بذلك خياراً جديداً، هو خيار ثورة الحرية والكرامة والقانون، الذي يمكن أن يتحول إلى مثال ونموذج يَعُم ُالعالم العربي، ويضع حداً نهائياً للدولة التسلطية العربية، بدأ يتداول في الخطاب الفكري والثقافي والسياسي العربي، مفهوم الدولة المدنية.
ربيع الثورات العربية وسؤال الدولة المدنية
وفي تونس ولد ربيع الثورات العربية هذا، ومنها أصبح يؤسس لتاريخ طريق بناء الدولة المدنية بوصفها مهمة صعبة وشائكة في العالم العربي، الذي يفتقر للخبرة والثقافة الديمقراطيتين.. وبما أن حركات الإسلام السياسي هي التي فازت في أول انتخابات ديمقراطية جرت في أكثر من بلد عربي، فقد برز اتجاهان يقدمان اجتهادات بشأن مقولة الدولة المدنية.
الأول يرى أن إقامة هذه الدولة ممكنة، إذ باستثناء النص على قيمة “الشورى”، فلا توجد نصوص أخرى في المرجعية الإسلامية تتناول الأمور السياسية. وإزاء صمت الفقه الإسلامي التقليدي عن معالجة نظم الدولة، فإنَ الباب ظل مفتوحًا لإقامة دولة إسلامية ليبرالية يختار فيها المواطنون مؤسساتهم السياسية كما يريدون، دونما حاجة للجوء إلى فصل الدين عن الدولة.
أما النوع الثاني من الليبرالية الإسلامية، فإنَه يذهب في تبريره تأسيس مؤسسات سياسية ليبرالية (كالبرلمان والانتخابات والحقوق المدنية) بل وحتى بعض سياسات الرعاية الاجتماعية، على أساس أنها لا تتناقض مع أي نصوص دينية، بل إنها يمكن أن تعد تطبيقاً لبعض المبادئ الإسلامية المنصوص عليها في بعض النصوص القرآنية، والتي يمكن استخلاصها أيضاً من سِيَر الخلفاء الراشدين.
ولعل هذه الاتجاهات المتنوعة في مجال الليبرالية الإسلامية هي التي جعلت بعض الباحثين المتخصصين في العالم العربي والإسلامي أكثر تفاؤلاً بإقامة هذه الدولة المدنية. غير أنَ حركات الإسلام السياسي في تحولاتها المعاصرة أثارت الخوف في داخل المجتمع التونسي خلال تجربة حكم الترويكا، بعدما اتجه أنصار الإسلام السياسي إلى تغيير نموذج المجتمع التونسي الليبرالي والمنفتح، وفق اجتهاداتهم المتنوعة.
لكنَ تجربة الانتقال الديمقراطي في تونس مثلت تجربة في بناء “الدولة المدنية” باعتبارها حلاً توافقيًا فريدًا من نوعه في المنطقة العربية، إِذْ شكلت قاعدة صلبة للعمل المشترك بين التيارين الإسلامي والعلماني، الذي عطل صراعهما طيلة ما يقارب القرنين من الزمان، أي إمكانية لإقامة أنظمة ديمقراطية تحترم الحريات وحقوق الإنسان، كما منع أي فرصة لتعبئة قوى الأمة العربية ومواردها لإطلاق مشروع حضاري يعيد العرب إلى سالف مساهمتهم العلمية والحضارية في تاريخ الإنسانية.

في هذا الكتاب الجديد، الذي يضم بين دفتيه مجموعة من الأوراق البحثية، التي تقدم بها عدد من المفكرين والباحثين الأكاديميين والنشطاء السياسيين، شاركوا في المؤتمر الذي نظمه المعهد العربي للديمقراطية في تونس بالشراكة مع مؤسسة هانس سايدل الألمانية، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 17 كانون الأول (ديسمبر) 2018، ويحتوي على 151 صفحة من القطع المتوسط، وصدر في شهر كانون الثاني (يناير) 2020، قدم المشاركون في المؤتمر، إسهامات أثروا بها هذا المشروع الفكري والسياسي المفتوح لـ “الدولة المدنية”، سواء فيما يتصل بالتجربة التونسية النموذجية، أو غيرها من التجارب الممكنة في عدد من الدول العربية.
دولة القانون في السيرورة التاريخية
لا يزال مفهوم الدولة المدنية حديث الاستعمال في الخطاب الفكري والسياسي العربي. فمفهوم الدولة المدنية طُرِحَ في سياق ما بات يُعْرَفُ بربيع الثورات العربية، للإشارة إلى رؤية جديدة لعملية الإصلاح، والعلاقة بين الحاكم والمحكوم في المجتمعات العربية، التي أسقطت الديكتاتوريات العسكرية والبوليسية، التي كانت قائمة.
وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن مفهوم الدولة المدنية غير متداول في الأدبيات الغربية وليس له وجود في المعاجم والقواميس السياسية في الغرب، لذلك فإن هذا المفهوم له مضامينه الخاصة في العالم العربي حيث طرح للتعبير عن تجربة خاصة بهذه المجتمعات العربية .
فما هي مرتكزات دولة القانون في المنظور الغربي؟
في هذا السياق يقدم الدكتور زيد الدليمي الكاتب والباحث الألماني من أصل يمني، والمدير الإقليمي لمؤسسة هانس سايدل الألمانية، في ورقته البحثية التي تحمل العنوان التالي: “الدولة المدنية على محك المقارنة بين النسقين الفكريين الألماني والعربي”، تعريفًا لدولة المواطن أو الدولة المدنية، فيقول: “في السياق الفلسفي الغربي، وجدت مفاهيم مجاورة لفكرة الدولة المدنية بيد أنها لم تعد ذات بال في النظريات السياسية، وعلى سبيل المثال اهتم قلة من المفكرين بنموذج “دولة المواطن”، رغم أن أرسطو وهو حجر الأساس في الفلسفة اليونانية القديمة قد مر على ذكره.
لا شك في أن ميلاد الدولة ـ الأمة، أساسها، وأصلها، ومعناها، تمظهر تاريخياً في ذاته ولذاته حسب تعبير هيغل،
وإذ تتميز “دولة المواطن” عن الأوليغارشية التي تحتكر فيها نخبة ضيقة سلطة الدولة، فإنها تختلف أيضًا عن الدولة الديمقراطية التي يشارك فيها كل المواطنين في رسم سياسة الدولة بكل حرية، ذلك أن “دولة المواطن” تتبوأ منطقة وسطى بين الأوليغارشية والديمقراطية: ففي هذا النموذج، تسير شريحة اجتماعية واسعة وهي الطبقة الوسطى الدولة لصالحها. وفي حين يغيب هذا المفهوم عن التداول اليوم، فإن غيرهارد بفرويدينشو يرسم في كتابه “من دولة الحزب إلى دولة المواطنين” ملامح يعلي من كلمة المواطنين داخل مجال الدولة لا بمعنى التمثيلية فحسب وإنما أيضا بمعنى المشاركة المباشرة.
وعلى هذا النحو فإن بفرويدينشو يضع للمرة الأولى الرأي المباشر للمواطنين في قلب الدولة وفي جوهر العملية السياسية ضمن إطار ما يُعرف بالديمقراطية المباشرة، كما يميزها بوضوح عن بقية أشكال الحكم المعهودة إلى أيامنا هذه بما فيها الدولة الدستورية القائمة على الأحزاب الديمقراطية. ويرى بفرويدينشوأن الديمقراطية التمثيلية قد آلت إلى حكم نخبة سياسية مضيقة لا تختلف جوهريا عمَا سبقها من نماذج تاريخية”(ص 24 من الكتاب).
مفهوم دولة القانون
ويركز الدكتور زيد الدليمي في ورقته البحثية على مفهوم دولة القانون التي انبثقت في سياق التحولات التاريخية الكبرى التي أصابت المجتمعات الأوروبية، منذ أن بدأ المشروع الثقافي التنويري الغربي الذي له خاصياته المتميزة يشق طريقه لجهة إخراج العقلانية من حدود الغيب والتجريد اللفظي إلى عالم المجهول المادي وإلى الطبيعة. وبذلك ولدت الدولة الحديثة بفضل الجهد التاريخي الذي قامت به الذات الأوروبية على ذاتها في مراحل الصراع التوتري الهائل بين العقل المسيحي والعقل العلمي الذي دام ثلاثة قرون، والذي تُوج بإحداث القطيعة الكبرى ـ وهي قطيعة معرفية وقطيعة إبستمولوجية وسياسية داخل استقلالية العقل نفسه ـ مع التصور الديني للعالم والحياة الذي أصبح معوِقاً للحداثة والتقدم وغير محتمل وغير مقبول في معارضة النظام المعرفي الجديد الذي شكلته البورجوازية كطبقة صاعدة في أوروبا.
لا شك في أن ميلاد الدولة ـ الأمة، أساسها، وأصلها، ومعناها، تمظهر تاريخياً في ذاته ولذاته حسب تعبير هيغل، حين بدأت العلاقات الرأسمالية تظهر تحت شكل الرأسمالية البضاعية، ومع اندلاع الثورة الديموقراطية البورجوازية التي عمت الغرب بدرجات متفاوتة الحدة والقوة منذ القرن التاسع عشر وفي أواخر القرن الثامن عشر، وعلى امتداد القرن التاسع عشر.
ولدت أشكال متنوعة عبر التاريخ من الدولة ـ الأمة، ففي إنجلترا، تشكلت الرأسمالية الصناعية من رحم الرأسمالية التجارية، وحققت البورجوازية “وفاقاً تاريخياً” مع الأرستقراطية بتحالفها مع النبلاء. غير أن التوازن النسبي للطبقات المسيطرة في مرحلة عملية التراكم البدائي لرأس المال الإنجليزي التي عرفت الكثير من العنف، لم يفسح في المجال لانبثاق دولة قوية كما هي الحال في فرنسا، بل عجل بقدوم “دولة معتدلة” حسب تعبير مونتسكيو، وعملت هذه السلطة السياسية المخفضة على إدارة هذا الوفاق في إطار التناقض بين الديموقراطية الداخلية والاستغلال الإمبريالي.
إن تبني نموذج دولة القانون في السياق العربي، لا يبدو بالضرورة حلاً مثاليًا على ضوء ما يشهده هذا النموذج من أزمات في موطنه الأول أي المجال الغربي
أما في فرنسا، فقد استولت البورجوازية على السلطة بوساطة الثورة العنيفة، وبسطت هيمنتها الطبقية على مجتمع ما زال زراعياً وتكمن المفارقة هنا في أن الهيمنة البورجوازية في فرنسا سبقت التوسع الصناعي والرأسمالية الصناعية التي عرفت انطلاقتها الفعلية تحت حكم الإمبراطورية الثانية ابتداء من عام 1850، على نقيض إنكلترا.
وهكذا، فإن المصادر النظرية للأفكار الثورية، وكذلك الممارسات المولدة للدولة الحديثة، ارتبطتا تاريخياً بحوامل موضوعية تجسدت في ذلك التفاعل العظيم بين إبداع الأفكار الثورية في الفيزياء والفلك والرياضيات وما نجم منها من تحولات علمية وصناعية كبرى، وحققت أسس رأسمالية صناعية متطورة، وبين طرح المناهج والأنساق المعرفية الجديدة في الفلسفة، التي تعتبر الإنسان ـ هذا العَلَمُ للثورة، والذي يتصور نفسه تارة كائناً طبيعياً، وتارة كائناً عقلياً ـ مركزاً للعالم، وطرحت في الوقت عينه التناقض بين مثالية القانون الطبيعي الذي بقي قاصراً منهجياً والقانون الوضعي المبني على العقلانية.
ويعتبر الحقوقيون أن الدولة الليبرالية للرأسمالية التنافسية التي ولدت في بلدان الغرب هي الشكل النموذج لدولة الحق والقانون بوصفها من أكثر الأنظمة ديموقراطية، وتمثل في الوقت عينه مركباً بين نظريات القانون الطبيعي أسبق منها ومبادئ حملها إليها القانون الوضعي في القرن الثامن عشر.
التجربة الغربية ومفهوم الدولة ـ الأمة
إنَ ما يتم التعبير عنه عبر دولة الحق والقانون، هو نشوء الدولة الحديثة في سياق التجربة الغربية، بدءاً من القرون الكلاسيكية التي أفرزت أشكالاً متعددة من الدولة القائمة على نظرية القانون الطبيعي، مروراً بالتحولات التي عرفتها المجتمعات الغربية منذ بداية الثورة الإنجليزية وحتى قيام الثورة الفرنسية، والتغيرات التي أدخلتها هذه الأخيرة على صعيد تجسيد القطيعة مع الأشكال السياسية للدولة الاستبدادية التي شهدت نشأة الرأسمالية المركنتيلية والتي عبرت عن إحدى المراحل الانتقالية من الإقطاعية إلى الرأسمالية، وإرساء الدولة القومية ـ الأمة التي تعتمد على فكرة سلطة القانون المطلقة، وبناء سياسي وقانوني يتجسد في مؤسسات مدنية تعتمد العمل الأيديولوجي وأخرى عسكرية وأمنية تعتمد العنف المشروع داخل حدود جغرافية معترف بها داخلياً وخارجياً. هذا الجمع بين البناء المدني السياسي والظاهرة القانونية وبين العنف المشروع داخل حدود معينة، هو أساس مفهوم الدولة ـ الأمة.
إنَ مفهوم الدولة ـ الأمة يتضمن في سيرورته الطابع الكوني العام الذي يحمله إلى العالم، لأن ظهوره ترافق مع ظهور الرأسمالية الناشئة، وانتشار علاقات الإنتاج الجديدة الخاضعة للرأسمال. فالبورجوازية الصاعدة تعمل على توطيد هيمنتها، وخدمة أهدافها على أساس أنها قيم حقائق، وتحقيق الوحدة القومية للأمة المتأمثلة للسوق الاقتصادية من خلال إلغاء الحواجز الجمركية الداخلية الموروثة من الانقسامات الإقطاعية، وانتزاع السيطرة والسيادة للسلطة السياسية من الرجعية الإقطاعية والمونارشية وإقامة دولتها، التي لن تكون أتوماتيكياً نتاج سيطرتها كطبقة، بل عبر الفتوحات التي تقوم بها لفرض هيمنتها والمرتبطة بخوض الصراعات السياسية المستمرة من أجل السلطة، الأمر الذي أظهرته بأكثر ما يكفي تاريخ الثورات، وبالأخص منها تاريخ الثورة الفرنسية الكبرى.
يبدو أن النظم الغربية الدستورية القائمة قد أصبحت رهينة السوق العالمية أو ـ وفقا لمصطلحات ماركس ـ رأس المال
خلافاً لما هو شائع الاعتقاد، فقد عرف العالم دولة “القانون” عبر العصور المختلفة التي مرت بها البشرية، منذ أيام حمورابي إلى يومنا هذا. لكن ما يميز الدولة الأوتوقراطية والديكتاتورية والتوتاليتارية في هذا المجال عن الدولة الديمقراطية هو كون القانون في الحالة الأولى جائراً، وشكلياً ولا عقلانياً، فضلاً عن انتهاكه وخرقه من السلطة عينها التي يفترض أنها تطبقه، أما في الحالة الثانية فهو يكفل للشخص الإنساني للمواطن، حقوقه الأساسية والحرية والمساواة أمام القانون، ويفسح له في المجال للدفاع عن حقوقه هذه، حتى في مواجهته الدولة التي يفترض أنها ضامنة لها.
يقول الدكتور زيد الدليمي: “إن تبني نموذج دولة القانون في السياق العربي، لا يبدو بالضرورة حلاً مثاليًا على ضوء ما يشهده هذا النموذج من أزمات في موطنه الأول أي المجال الغربي. وعلى النحو الذي تنبأ به كارل ماركس للدولة البرجوازية في عصره، يبدو أن النظم الغربية الدستورية القائمة قد أصبحت رهينة السوق العالمية أو ـ وفقا لمصطلحات ماركس ـ رأس المال، إذ يبدو أن المستفيد الأول ـ والأوحد ربما ـ من الحريات الموعودة في السياق الغربي هي النخب الاقتصادية والمالية المتنفذة، كما يبدو أن المساهمة الأبرز للدولة في الغرب لا تتمثل في الحرية الفردية الموعودة بقدر ما تكمن في فتح المجال أمام تغول رأس المال على خلاف الحرية الفردية الموعودة…إن السردية القائلة بنظام رأسمالي لا يقبل التشكيك كثيرًا ما تُلازم الاعتقاد في نموذج دولة القانون الديمقراطية باعتبارها نموذجًا كونيًا و”رزمة غربية” صالحة للعالم بأسره.
بيد أن ذلكم الاعتقاد لا يزال يثير ريبة الثقافات الأخرى التي تطمح إلى تطوير نموذج في التنمية السياسية والاقتصادية يستجيب لخصوصياتها وشروط فخرها بذاتها الحضارية. وتدريجيًا تؤدي هذه السردية الغربية إلى حالة من الضجر من مقولات الديمقراطية ودولة القانون باعتبارهما تعبيرًا فضًا عن المركزية الأوروبية وفرضية سائدة تلتقي فيها البداهة مع البلادة” (ص 34 ـ 35 من الكتاب).
آراء في الفكر السياسي العربي ومعارك بناء الدولة الدستورية
على غير عادة الثورات في التاريخ، جاءت ثورات الربيع العربي التي انطلقت من تونس أواخر العام 2010 مفاجئة للجميع، ليس فقط في نوعيتها وأنها شعبية ومن دون قيادات سياسية أو فكرية، وإنما أيضا لأنها فتحت الباب لإعادة كتابة التاريخ السياسي الحديث والمعاصر للمنطقة العربية.
وعلى الرغم من مرور نحو عقد من الزمن على انطلاق هذه الثورات، مازال المفكرون وعلماء الاجتماع والسياسة يحاولون فهم ديناميكية الثورات العربية وأهم العوامل المؤثرة فيها وآفاقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ضمن هذا الإطار يأتي الكتاب الصادر عن المعهد العربي للديمقراطية بتونس، “الدولة المدنية.. التصور والواقع والممكن “، لمجموعة من المؤلفين، الذي يعرض له الكاتب والباحث التونسي توفيق المديني، بدأه بقراءة في الثورة التونسية وشروط قيام الدولة المدنية عربيا، ويواصل في الجزء الثاني قراءة مشروع الدولة المدنية كما يفهمه العرب.
مفهوم الدولة المدنية في السياق العربي
تبدو فكرة الدولة المدنية واعدة، فمن ناحية تنطوي هذه الفكرة على تأثير المجتمع المدني والذي يبدو مرحبا به في المجال العربي، إذ يفتح نموذج الدولة المدنية الباب أمام انطلاقة جديدة في نظرية الدولة من زاوية اصطلاحية.ويتناول مفهوم الدولة المدنية على عدة مستويات وهي الشكل والمضمون والسياق التاريخي والموضوعي لمفهوم الدولة المدنية.
فالدولة المدنية يجب أن تقوم على دستور ومنظومة من القواعد التشريعية والتنفيذية، فالدستور يبلور جملة القيم والأسس التي ارتضاها أفراد المجتمع لبناء نظامه السياسي والاجتماعي. والدولة المدنية هي أيضا دولة مؤسسات، وتقوم هذه المؤسسات على مبدأ التخصص فهي تمارس أعمالها بشكل مستقل وفق ما يعرف بمبدأ فصل السلطات، بحيث تقوم كل سلطة بممارسة مهامها ضمن مجالها المحدد ولا تتجاوزه الا في حدود ما تقتضي ضرورات التعاون والتكامل بين هذه السلطات.
ومن المعالم الأساسية للدولة المدنية وجود مجتمع مدني فاعل ومؤسسات مدنية فاعلة للنهوض بمستوى الوعي السياسي لدى أفراد المجتمع والمساعدة في فهم الواقع السياسي والاجتماعي فهماً صحيحاً والمشاركة في بناء مؤسسات ديموقراطية وممارسة الرقابة عليها من خلال التنظيمات المدنية المختلفة والوسائل الإعلامية والرقابية المتاحة.
ضمن هذا السياق، يقدم المفكر العراقي الدكتور عبد الحسين شعبان، في ورقته البحثية التي تحمل العنوان التالي: “عن مفهوم الدولة المدنية وأنواعها مساهمة في النقاش حول مأزق الدولة العربية المعاصرة”، طرحا متميزًا، إذ يقول: لعلَ جزءًا من النقاش الذي يعلو اليوم وبنبرة صاخبة له علاقة بالمأزق التاريخي والثقافي الذي وصلت إليه الدولة العربية الحديثة، التي ظلت تترنح تحت ضربات الاستبداد بمبررات دينية أو علمانية، يمينية أو يسارية، وهو الأمر الذي ينتظر منها مواكبة حثيثة لسير تطورها قانونيًا ودستوريًا، وما يميزها عن سواها من دول تيوقراطية أو أوتوقراطية أو أنظمة مطلقة أو دكتاتورية أو عسكرية.
وعلى الرغم من “نعومة” مصطلح” الدولة المدنية” قياسًا لمصطلح “الدولة العلمانية” الذي يثير حساسية شديدة ورفضًا واسعًا من الأوساط الدينية بشكل خاص، يصل أحيانًا إلى اتهام دعاته بالخروج عن الدين و الكفر والإلحاد، فإنَ مصطلح” الدولة الدينية” هو الآخر يواجه ردود فعل حادة تصل أحيانًا إلى درجة التعرض للدين، من جانب جمهور واسع وقوى متعددة يسارية ويمينية، اشتراكية وقومية وليبرالية، الأمر الذي يضع فكرة” الدولة المدنية” بين مصطلحين متناقضين لدرجة التناحر الأول ـ الدولة الدينية و الثاني ـ الدولة العلمانية.
المصطلحان “الدولة الدينية” و”الدولة العلمانية” يثيران أسئلة أخرى مشتبكة مع عديد من القضايا التي يواجهها الفكر العربي الإسلامي من جهة، و الممارسة العملية من جهة أخرى، خصوصا ما يتعلق بمدى انطباقه على واقع الحال بغض النظر عن التسميات والتوصيفات. ومع ذلك فالمفهوم الذي يتم الترويج له تأييدًا أو تنديدًا لفكرة “الدولة المدنية” لا زال لم يجد البيئة الحاضنة له على المستوى العربي الإسلامي، وهو ما يحتاج إلى عملية “تعريب” أو “تبيئة” أو”توطين”، باعتباره جزءًا من التطور الدستوري على الصعيد العالمي مع عدم نسيان الخصوصية الدينية والثقافية…” (ص 38 ـ 39 من الكتاب).
في مضمون الدولة المدنية
الدولة المدنية هي استعادة حقيقية لبناء الدولة الوطنية والارتقاء بها إلى دولة ديمقراطية، أي إعادة إنتاج الدولة الوطنية الحديثة، دولة الحق والقانون المعبرة عن الكلية الاجتماعية والقائمة على مبدأ المواطنة. وتشكل سيادة الشعب، العامل الحاسم في سيرورة التحول الديمقراطي في نطاق الدولة الوطنية.
وتكمن المقدمة الأولى للدولة الوطنية وضمان تحولها إلى دولة ديمقراطية، في تحرر الأفراد من الروابط والعلاقات الطبيعية ما قبل الوطنية كالعشائرية، و العرقية، والمذهبية، والطائفية، واندماجهم في فضاء اجتماعي وثقافي وسياسي مشترك هو الفضاء الوطني .
فالدولة المدنية لا يمكن أن تكون إلا دولة ديمقراطية التي تقوم على ما يلي: احترام حقوق الإنسان أولاً، وحقوق المواطن ثانياً، وفكرة الأكثرية الانتخابية الحرة التشكيلية، ثالثاً، وضمان التداول السلمي للسلطة على جميع المستويات وفي كافة مؤسسات الدولة، رابعاً.
فالدولة المدنية لا يمكن أن تكون إلا ديموقراطية لأنها تستبعد الاستئثار بالسلطة وتعتمد الرجوع إلى القاعدة بشكل دوري. والديمقراطية هنا هي الليبرالية مفهومة فهماً جدلياً وتاريخياً صحيحاً بالإضافة لمفهوم الشعب، وهذا الأخير مُؤَسس على مفهوم الوطن والمواطنة، ونفي “الحرب خارج المدينة”، أي نفي العنف بكل صوره وأشكاله، ونفي الحرب خارج حدود الوطن ونطاق الأمة.
إنَ الدولة المدنية ليست بدولة عسكرية، وليست أيضاً بدولة دينية، لكنها ليست بالضرورة أن تكون دولة علمانية بالمعني الغربي للكلمة. فالدولة المدنية ترفض الدولة الدينية “الثيوقراطية”، وتستبعد إسناد عملية الحكم إلى فئة من رجال الدين أو الفقهاء لأن السياسة والإدارة والقانون والاقتصاد هي تخصصات يؤهل لها من يمارسها تأهيلاً خاصاً كما يؤهل رجل الدين أو الفقيه أو العالم بالقضايا الشرعية في المعاهد والكليات الشرعية ولا يمكن لأحد أن يحل محله في الإفتاء والاجتهاد في القضايا الشرعية وكما نعترف لرجل الدين بعلمه وكفاءته في الإفتاء في الأمور الدينية فيجب أن نقر لرجل الاقتصاد والقانون والإدارة والسياسة بخبرته وتأهيله للقيام بالعمل الحكومي وبالتالي فإن الدولة المدنية لا تقبل بإسناد عملية الحكم للفقهاء أو رجال الدين لمجرد أنهم علماء بأمور الدين ويرتدون عباءة الفقيه.
المقدمة الأولى للدولة الوطنية وضمان تحولها إلى دولة ديمقراطية، في تحرر الأفراد من الروابط والعلاقات الطبيعية ما قبل الوطنية كالعشائرية، و العرقية، والمذهبية، والطائفية، واندماجهم في فضاء اجتماعي وثقافي وسياسي مشترك هو الفضاء الوطني .
فالدولة المدنية لا ترفض الدين ولا تعاديه ولكنها ترفض استغلال الدين لأغراض سياسية، فهي ترفض إضفاء طابع القداسة على الأطروحات السياسية لأي من الفرقاء في العمل السياسي أو تنزيه أي رأي من الآراء أو اجتهاد من الاجتهادات عن النقد أو النصح والتوجيه. فالإسلام يفرق بين الوحي وبين الاجتهاد في فهم وتفسير الوحي فلا يعطي لهذه الاجتهادات لذاتها قداسة وإنما يقبلها بقدر ما تقدمه من حجج على صحة فهمها وتفسيرها للكتاب والسنة. ومن جانب آخر فإن الدولة المدنية ترفض نزع الإسلام من ميدانه الروحي ومن مجاله المقدس والزج به في المجال المدنس الذي هو مجال الصراعات والمؤامرات والألاعيب السياسية.
الدولة المدنية من هذا المنظور هي دعوة للانفتاح ودعوة لاستيعاب تراث فكرالحداثة الغربية، لا سيما في مجال قضية حقوق الإنسان،باعتبارها القضية المركزية في نسق الحداثة وفي منظومتها القيمية، وفي الثقافة الديمقراطية سواء بسواء. ولا يمكن فصل مقولة الحرية أو مشكلة الحرية، بتعبير الفلاسفة، عن قضية حقوق الإنسان وكرامته. ومن المهم أن نلاحظ أن قضية الحرية كانت غائبة عن الثقافة العربية وعن الفكر السياسي خاصة، ولا تزال غائبة، ولذلك من السهل تذويب الفرد في العشيرة والطائفة والجماعة الإثنية.
غياب الدولة الدستورية العربية
حين تصبح عملية الانتقال إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع مستحيلة في العالم العربي، جراء ضعف التغيير من خلال المؤسسات التي لا تؤمن الترابط الاساسي في النظام الديمقراطي، بين القرار والمسؤولية، نتاج لجوء الحكام الى تفصيل ديمقراطيات على مقاس أبنائهم من بعدهم، تطرح النخب الفكرية والثقافية والديمقراطية العربية سؤالاً جامعاً، أيهما كان أفضل أن يتم التغيير في أي بلد عربي بواسطة تدخل القوى الأجنبية كما حصل في العراق، حيث دفع الشعب العراقي ثمناً باهظاً جداً، وخلق حالاً من الفوضى وعدم الاستقرار، أو من قبل المؤسسة العسكرية والأمنية ـ كشكل وحيد للتغيير من الداخل من دون دعم من الخارج؟
إنَ رفض الديمقراطيين العرب لهذه الاشكال من الانتقال إلى السلطة الآنفة الذكر ينطوي على الكثير من الصدقية، ولا سيما أنَ معظم مآسينا كعرب جاءت من انقلابات عسكرية أو دستورية ـ ولا فارق هنا بين هذا وذاك ـ قدمت لنا في بدايات حكمها مشاريع سياسية براقة ما لبثت أنْ تحولت الى أوهام وخراب، حين تمسك الانقلابيون بالحكم بصورة إطلاقية، وأخفقوا في مجال التنمية المستقلة، وفي عملية تحرير الأرض السلبية، وبناء الديموقراطية.
يكاد لا يخلو أي دستور دولة عربية من الإشارة الواضحة إلى بنوده المتعددة إلى احترام المؤسسات، واحترام القانون، والحرِيات الفردية والعامة، والتداول السلمي للسلطة. ومع كل ذلك، فإنَ الباحثين السياسيين وعلماء الاجتماع المهتمين بتأصيل فلسفة سياسية عقلانية عن الدولة الحديثة والمجتمع المدني في العالم العربي يعتقدون جازمين أنَ المؤسسات وأشكال التمثيل السياسية مأزومة، بدءاً من دور البرلمان، الذي لم يعد يتحكم بجدول أعمال جلساته، مروراً بشخصنة النقاشات عبر لعبة الانتخابات، أو من خلال إفراغ فصل السلطات من معناه.
ما زال الفكر السياسي العربي يفتقر افتقاراً فعلياً الى بلورة نظرية حول طبيعة الدولة الدستورية العربية، وهو ما يشكل واحدة من أهم أزماته، فضلاً عن أنه يتجاهل التمييز بين الدولة والسلطة
يمكن التعرف في واقع الدولة العربية ما بعد الاستقلال السياسي، إلى أن سير تطور بنيتها وخصائص وظائفها الاقتصادية، أم السياسية القمعية، أم الدمجية، أم التقنية تختلف عن السيرورة التاريخية لتبلور الدولة البورجوازية في الغرب (أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية)، بسبب من تطورها كدولة رأسمالية في ظل الرأسمالية المتأخرة، لعبت دور جس للبورجوازية الاحتكارية الامبريالية، ومفوض وكيل للرأسمال الدولي، وتقوم بوظائف إعادة الانتاج المندمج في السوق الرأسمالية العالمية، وبالتالي إعادة انتاج سيرورة الاستغلال من جانب رأس المال.
وليس من شك أن هذه العلاقة الأدواتية قد أسهمت في تقليص السيرورات السياسية ضمن وبين مكونات المجتمع المدني الوليد، وتحويل هذه الدولة ذاتها ـ التي هي بالأساس دولة لا قانونية حيال غالبية الشعب من دولة في ظل “اللحظة الليبرالية” التي عرفها العالم العربي، التي تقوم على مؤسسات مستقلة نسبياً في اطار وظيفتها الى دولة سلطة، أعادت انتاج مؤسسات الدولة وفق مصالح الفئة الحاكمة، حتى بات التمييز صعباً بين السلطة والدولة.
يتفق علماء الاجتماع والسياسة على أنَه ليس هناك دولة دستورية في العالم العربي، ومشروعيتها، بالمقارنة مع دولة القانون التي وضعتها الثورات الديمقراطية البورجوازية المتعاقبة في الغرب، وركائزها الحديثة باعتبارها دولة تقوم على المذهب الوضعي الذي يستند بدوره الى الفكرة القائلة إنَ الدفاع عن القانون يقوم على الحرية. وفي ظل غياب الحرية ينعدم القانون.
وما زال الفكر السياسي العربي يفتقر افتقاراً فعلياً الى بلورة نظرية حول طبيعة الدولة الدستورية العربية، وهو ما يشكل واحدة من أهم أزماته، فضلاً عن أنه يتجاهل التمييز بين الدولة والسلطة، لأن فكرة الدولة في العالم العربي لم تتغير كثيراً عن معنى الدولة قبل الأزمنة الحديثة، حيث كان معنى الدولة عند ابن خلدون على سبيل المثال هو مدة حكم أسرة حاكمة تبعيتها، أو الامتداد الزماني والمكاني لحكم عصبية من العصبيات، سواء أكان هذا الحكم عاماً أو خاصاً.
وحين نتأمل في أحوال الدولة العربية الراهنة، فإننا نجدها متماثلة مع السلطة، بما أن هذه الدولة على الرغم من أنها ذات دستور، تقلصت الى حدود العاصمة بحكم مركزية السلطة فيها، وبالتالي فهي دولة هذه العاصمة، لا دولة الأمة ولا دولة الوطن، وهي ليست دولة جميع المواطنين المتساوين أمام القانون، بل هي دولة متحيزة لحزب مهيمن أو لطبقة، أو لدين أو لطائفة أو لأثنية أو لاقليم بعينه. وهنا يكمن الفارق بين دولة عربية ذات دستور وبين دولة دستورية. فالدولة الدستورية هي تلك الدولة التي تقوم قولاً وفعلاً على احترام الحرية السياسية باعتبارها أصل الحريات وشرط تحققها، فبانعدامها تتعذر ممارسة “حرية الفكر والعقيدة والتملك” على حد قول مونتسكيو.
والحرية السياسية لا توجد إلا في ظل الدول التي تحترم القانون، بينما الدولة العربية ذات الدستور، فتلك التي تنتهك القوانين والانظمة السائدة، لمصلحة النخبة الحاكمة، وتصادر الحريات وتعرضها للضرر والانتهاك، وترفض ايضاً اقامة نوع من التوازن السياسي عبر الالتزام بمبدأ فصل السلطات، بوصفه أداة فنية تجعل التعايش بين المؤسسات الدستورية أمراً ممكناً، ووسيلة للتوفيق بين المشروعيات المتنافسة والمتصارعة داخل المجتمع السياسي. وهذا هو مصدر نشوء الاستبداد في التاريخ السياسي العربي المعاصر.
يعني مصطلح”دستور”، الذي يقابله في الفرنسية Constitution، “التأسيس أو البناء”، أي التنظيم أو القانون الأساسي، فهو يحيل على مرجعية مفادها البحث عن الأسس الكفيلة تأصيل وضبط ممارسة السلطة وتنظيم مؤسسات الدولة، وعلى خلفية ذلك يفسر لماذا ارتبط مفهوم الدستور بالدستورانية الأوروبية الهادفة، مع مطلع القرن الثامن عشر، إلى إعادة بناء الدولة والسلطة على تصورات فلسفية وآليات تنظيمية جديدة.
بيد أن الدستور وحده لا يكفي لاكتساب الدولة المشروعية المطلوبة، بل تصبح المشروعية Legitimite حقيقة مقبولة حين تتعزز وثيقة الدستور بالاحترام وتحاط بالشروط الكفيلة بضمان صيانتها، أي حين تتحقق الشرعية الدستورية.
إن ما يميز الدستور الديمقراطي Constitution democratique ويجعله جديرا بهذه الصفة استناده على جملة مقومات تضفي صبغة الديمقراطية عليه، وتبعده عن الدساتير الموضوعة إما بإرادة منفردة، كما هو حال الدساتير الممنوحة، أو عبر استفتاءات مفتقدة إلى شروط الاستقلالية والحياد والنزاهة.
لعل أهم مقومات الدستور الديمقراطي:
أولاً ـ تأسيسه على مبدأ المواطنة الكاملة المتساوية والتسليم بأن الشعب مصدر السلطات
ولاسيادة لفرد أو قلة عليه .
ثانياً ـ حكم القانون
ثالثاً ـ أن يحترم فيه فصل السلطات
رابعاً ـ تؤكد فيه الحقوق والحريات
خامساً ـ ان يتم الاعتراف بالتداول السلمي للسلطة بين الأغلبية والمعارضة. هذا بالإضافة إلى
الطريقة التي يوضع بموجبها الدستور من قبل جمعية وطنية تأسيسية منتخبة.
دستور الثورة التونسية حسم العلاقة بين الدين والدولة
على غير عادة الثورات في التاريخ، جاءت ثورات الربيع العربي التي انطلقت من تونس أواخر العام 2010 مفاجئة للجميع، ليس فقط في نوعيتها وأنها شعبية ومن دون قيادات سياسية أو فكرية، وإنما أيضا لأنها فتحت الباب لإعادة كتابة التاريخ السياسي الحديث والمعاصر للمنطقة العربية.
وعلى الرغم من مرور نحو عقد من الزمن على انطلاق هذه الثورات، مازال المفكرون وعلماء الاجتماع والسياسة يحاولون فهم ديناميكية الثورات العربية وأهم العوامل المؤثرة فيها وآفاقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ضمن هذا الإطار يأتي كتاب المعهد العربي للديمقراطية بتونس، “الدولة المدنية.. التصور والواقع والممكن “، الذي يعرض له الكاتب والباحث التونسي توفيق المديني، بدأه بقراءة في الثورة التونسية وشروط قيام الدولة المدنية عربيا، ثم قراءة مشروع الدولة المدنية كما يفهمه العرب، وانتهاء اليوم بالدستور التونسي كنموذج عربي للانتقال الديمقراطي.
أهمية الدستور الديمقراطي في تونس
في الدستور التونسي الجديد، لم يتم التنصيص صراحة على أن “الشريعة الإسلامية مصدر للتشريع”، بل تم الاكتفاء بالفصل الأول من الدستور التونسي الذي وُضِعَ سنة 1959، وهو ما ورد في صياغة مشروع الدستور الجديد، حيث جاء في الفصل الأول: “تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها”، كما جاء في الفصل الثاني: “تونس دولة مدنية، تقوم على المواطنة، وإرادة الشعب، وعلوية القانون”.
وهكذا، فإن الإسلام هو دين الشعب التونسي، من دون ذكر أنه دين الدولة. فهذه التوليفة الخلاقة التي ابتدعها الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة شكلت الجسر إلى بناء الدولة المدنية في تونس. فهذا الفصل الأول من دستور 1959، والذي تم تبنيه بالكامل في الفصل الأول من دستور 2014 ينص على أن الإسلام هو دين التونسيين وليس عقيدة الدولة.
وتنظر النخب العربية إلى هذا التتويج الدولي لتونس بمنحها جائزة نوبل للسلام في سنة 2015، عبر الرباعي الراعي للحوار الوطني، بأنه لم يكن صدفة ولا حدثًا طارئًا أو مفاجئًا بل كان التتويج الطبيعي لمسار طويل من الحركة الإصلاحية التونسية بمدونتها التنويرية والتحديثية العميقة والعريقة، التي بدأت منذ القرن الثامن عشر، واستمرت حتى حصول تونس على استقلالها في 20 آذار (مارس) 1956.وقد كانت لهذه الحركة الإصلاحية التنويرية محطات واضحة راكمت العمق التاريخي لتونس الذي بدأ مع دستور قرطاج ومدونة القديس سانت أغسطين وتأسيس بيت الحكمة في القيروان وجامع الزيتونة أعرق جامعات العالم .
خير الدين التونسي.. رمز الإصلاح
منذ عصر النهضة العربية الأولى، يعتبرالمصلح خير الدين التونسي من أعظم المنظرين العرب لجهة مطالبته بضرورة اقتداء أقطار العرب الحديثة بفلسفة ونهج الحداثة الأوروبية الغربية، ومعرفة أساس قوة أوروبا وازدهارها، وبكيفية خاصة دور الدولة الحديثة ومؤسساتها السياسية القائمة على الحرية في المجتمع المدني. وأسهم المصلح خير الدين في وضع الدستور الأساسي ،أو دستور عهد الأمان في سنة 1861 الذي يعتبر أول دستور عربي يقر في بلاد الإسلام، وهو متكون من ثلاثة عشر فصلاً، ومئة وأربعة عشر مادة مرقمة حسب الطريقة الفرنسية.
إنَ دستور عهد الأمان للعام 1861، قَوَضَ سلطة الباي، وأصبحت تونس عبارة عن دولة ملكية دستورية، إذ أن مجلس الشورى الأعلى هو الذي يُصَدِقُ على إجراءات الحكومة قبل تنفيذها، فضلاً عن أن السلطة الفعلية قد أصبحت في أيدي رئيس الحكومة، أو الوزير الأول حسب المصطلح الفرنسي. ويضمن الدستور الأمن الكامل للأشخاص، والممتلكات، وشرف كل سكان المملكة، بصرف النظر عن ديانتهم، وجنسيتهم، وعرقهم. وعندما اعتكف المصلح خير الدين عن العمل السياسي وضع كتابه الوحيد باللغة العربية بعنوان”أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك “، نشر لأول مرة في تونس العام 1867، حيث لاقت ترجمة مقدمته بعنوان ” الإصلاحات الضرورية للدول الإسلامية ” صدى كبيرا في فرنسا، نظرا لما تنطوي عليه من صياغة لمشروع نهضوي حديث.
ويعلق المفكر العربي البرت حوراني على ذلك بقوله: “يبدو أن خير الدين وضع هذا الكتاب وهو على شيء من الاعتقاد أنه يفعل للعصر الحديث ما فعله ابن خلدون لعصر أسبق. فالمؤلفان تونسيان وضعا كتابيهما في فترة عزلة عن الحياة السياسية، وعالجا فيهما، كل على طريقته قضية نشوء الدول وسقوطها. وقد قسم كل منهما كتابه إلى مقدمة لعرض المبادئ العامة وإلى أجزاء عدة. إلا أن التشابه يقف عند هذا الحد. ففيما يعني كتاب ابن خلدون، في معظمه،بتاريخ الدول الإسلامية، يعني كتاب خير الدين، في معظمه أيضاً، بتاريخ الدول الأوروبية وتركيبها السياسي وقوتها العسكرية”.
وشاع مفهوم الدستور في تونس في عشرينات القرن الماضي مع الشيخ عبد العزيز الثعالبي، مؤسس الحزب الليبرالي الدستوري الذي قاوم الاستعمار الفرنسي ، ثم استعاده وطوره ابتداءً من العام 1934 أبوالاستقلال الحبيب بورقيبه، بحيث بات يشكل عنصراً موجهاً في تأكيد الهوية السياسية التونسية.واتُخذ هذا المفهوم وسيلة لبلوغ الحداثة القضائية والمؤسساتية، واندرج في سياق قطيعة مع النظام الاستعماري ومع الاستبدادية البايوية (نسبة إلى الباي) .لكن لم يبدأ الوطنيون بالتعبير بشكلٍ واضح عن ضرورة إنشاء مجلسٍ تأسيسي إلا بعد وصولهم إلى عتبة السلطة في 20 آذار (مارس) 1956.
ولما كان الحزب الحر الدستوري بزعامة الحبيب بورقيبة هو قائد مسيرة استقلال تونس وباني الدولة الحديثة، فقد طرح انتخاب المجلس التأسيسي ،بهدف صياغة الدستورالجديد ،فوجد الملك العجوزسيدي لامين نفسه مُجْبَراً تقريباً على أن يوقع، في 29 كانون أول (ديسمبر) 1956، وبختمه على أسفل صفحة المرسوم الذي دعا إلى الانتخابات في 25 مارس من عام 1956. وقد حاول مع ذلك أن ينقذ ما أمكنه بالحَدِ من صلاحيات المجلس التأسيسي وبتخصيصه بمهمة واحدة محددة بدقة:” وضع دستورٍ خاص بمملكة تونس”.
بعد انتخاب المجلس التأسيسي، اجتمع للمرة الأولى في 8 نسان (أبريل) العام 1956، في قاعة العرش في قصر باردو، بما له من رمزية، انتخب بورقيبه رئيساً له. وبعد ستة أيام أقر قانوناً دستورياً مولفاً من مادة وحيدة بثلاث فقرات، هو “الدستور الصغير العام 1956”. وأدرك بورقيبه أن مسألة العلاقة بين الدين والدولة قد تلهب النفوس وتحرك المشاعر التي لا طائل لها، فأراد مُسَبَقاً أن يقفل باب النقاش. هكذا جاءت الفقرة الأولى من القانون الدستوري الصادر في 14 إبريل العام 1956، والذي سوف تنقل حرفياً تقريباً في المادة الأولى من دستور الأول من يونيو العام 1959 تحفةً في الاقتضاب والغموض: “تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة. الإسلام دينها والعربية لغتها”. فالإسلام”دين دولة” وليس “دين الدولة”؛ في حين تم”الاعتراف” بحرية المعتقد وحرية ممارسة المعتقدات “المحمية شرط ألا تخل بالنظام العام” (الفقرة الثالثة). بالتالي لم يجعل الدستور من تونس دولةً لائكية، لكنها لم تكن دولةً إسلامية. كانت دولةً علمانية (مدنية أو زمنية)، لأن الشريعة لم تكن فيها مَصْدَرًا للتشريع .أما الفقرة الثانية، وقد نصت على أن “الشعب التونسي هو صاحب السيادة يباشرها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور”، ما نزع صلاحيات الباي؛ بحيث ووجدت الملكية نفسها عملياً تتراجع إلى صفوف مؤسسةٍ عادية عامية.
عندما أطاح بورقيبة بالملكية وسلطة الباي في 25 تموز / يوليو 1957، بإعلانه ميلاد الجمهورية التونسية، تغيرت المعطيات رأساً على عقب؛ وبات على المجلس التأسيسي أن يستأنف الورشة من حيث أوقفت في 14 نيسان (أبريل) العام 1956. وأنجز المجلس التأسيسي المنتخب في فجر الاستقلال (1956 ـ 1959) صياغة دستور عام 1959، الذي احتل مكانة بارزة في تأسيس النظام الجمهوري، وبناء الدولة التونسية الحديثة التي تبنت فلسفة الحداثة بكل منطوياتها الفكرية، عبر تركيز أسس دولةٍ مدنية من النوع العقلاني ـ الشرعي، ما كان حتى ذلك الوقت محصوراً فقط بالحداثة الغربية. لكن المجلس التأسيسي في ذلك الوقت أخفق في إرساء نظام ديمقراطي، وضمان الحقوق والحريات بشكل فعال. واحتوى دستور سنة 1959 على 64 فصلا وأدخلت عليه خلال السنوات اللاحقة عديد التعديلات منها ما كان في عهد الحكم البورقيبي، ومنها ما كان في العهد النوفمبري وانتهي إلينا سنة 2010 قبيل الثورة مكونا من 78 فصلاً .
إنَ التوقف عند هذه المحطات التاريخية أكثر من ضروري بالنسبة للتونسيين اليوم وخاصة الجيل الجديد من الشباب الذين لا يعرفون لماذا حازت بلادهم جائزة نوبل، فمنح هذه الجائزة الدولية الأولى لتونس ليس صدفة.فقد توفرت لتونس كل أسباب الإستثناء ونجاح التجربة الإنتقالية في تونس لحد الان ونجاة البلاد من حرب أهلية،هو ثمرة هذا الإرث الطويل من تجذر المشروع الإصلاحي التونسي الذي لم يبدأ اليوم ولا بالأمس،ولم يُولَدْ مع 14 جانفي/يناير 2011،بل كان سلسلة حلقات متراكمة بدأت مع العصر القرطاجني والعربي الإسلامي وتجذر في العصر الحديث بدءًا من القرن الثامن عشرتحديدًا.إنها تونس العظيمة التي تتجدد ولا تموت .
لقد كان الخطاب الديمقراطي في تونس ضبابياً وملتبساً في مقولاته، فالأحزاب السياسية على اختلاف مرجعياتها الفكرية والسياسية لم تركزعلى طرح أفكار الحرية الدستورية، والعلمانية، والمساواة المواطنية، وحقوق الانسان والمرأة، حتى لا يسع المرء إلا أن يتساءل: ما هي تلك الديموقراطية التي تتحدث عنها الطبقة السياسية التونسية والأحزاب السياسية ، ما جوهرها وأسسها ومراميها، وكيف يمكن أن تجمع تحت لوائها كل تلك المتناقضات الأيديولوجية والسياسية وكل تلك التوجهات المتنافرة في الأهداف والغايات والمصالح؟ هل يكفي أن يؤمن الجميع بالانتقال السلمي إلى نظام ديموقراطي ولو غير محدد الأهداف والأسس؟ وهل سيلبي هذا النظام حاجات وتطلعات هؤلاء دون الإخلال بالأمن السياسي أو الاجتماعي أو بمصالح كل فريق من الفرقاء؟ كيف ستتأمن في نظام جامع مصالح الأغنياء والفقراء والطوائف والمؤمنين بحقوق الانسان والمرأة واولئك الذين لا يعترفون بكل هذه الحقوق؟
وفي هذا السياق، استطاعت تونس أن تُصَحِحُ ربيع “الثورات العربية”، وتُؤَكِدُ الاستثناء التونسي في تَفَرُدِهِ على الموافقة على دستور ديمقراطي وليبرالي وتوافقي في آن معاً، وهي بهذه الخطوة أنهت المرحلة الانتقالية بعد انتظار دام لنحو سنتين ونصف.إنهااللبنة الأولى في بناء مؤسسات الدولة المدنية الديمقرطية التعددية، التي عجزت الأديولوجيات الشُمُولِيَة (الإسلامية والقومية والماركسية) عن بنائها في العالم العربي، لكن الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة المتشبع بالثقافة الفرنسية والمتأثر بكمال أتاتورك، كان أول من أرسى الدولة المدنية ذات الاتجاه العلماني عند العرب،لا سيما أن الدولة المدنية ليست بدولة عسكرية، وليست أيضاً بدولة دينية، لكنها ليست بالضرورة أن تكون دولة علمانية بالمعنى الغربي للكلمة.