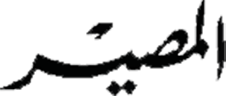د.خالد شوكات: الانتقال الديمقراطي والسرديات المجروحة
1 min read

د.خالد شوكات
منح الانقلاب على مسار الانتقال الديمقراطي الذي نفذه رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية/يوليو 2021، فرصة لمراجعة العشرية الأولى لهذا المسار ونقدها ورسم الرؤية المستقبلية بناء على ذلك، إذ ما كان لهذا الانقلاب أن يحدث لو لا مجموعة الأخطاء الكبرى التي ارتكبت من قبل كل من تحمل مسؤولية إدارة المسار، سواء من موقع الحاكم أو من موقع المعارض، ففي السياقات الديمقراطية عادة ما تكون المسؤولية تشاركية وتبعاتها مشتركة.
إن الجهود المبذولة لاستعادة المسار الطبيعي للانتقال الديمقراطي، وايقاف التمشي الانقلابي، تشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الرؤية المستقبلية المنشودة، ولهذا يستوجب الموقف تقييم هذه الجهود وتقويمها ان بدا عليها الانحراف، فاستعجال إيقاف الانقلاب أو اختزال المعركة السياسية في هذا الإيقاف قد يقود إلى العودة إلى وضع مشابه لذلك الذي أفرزه وبرره وقاد إليه، لأن نفس الأسباب غالبا ما تقضي إلى ذات النتائج، ومن هنا أهمية كل عمل يجمع بين هذا الالتزام النضالي الميداني الهادف إلى تعبئة القوى الديمقراطية في معركة التصدي للانقلاب، والاجتهاد الفكري الرامي إلى بلورة مشروع حضاري وطني يضمن عدم تكرار الأخطاء وتوافقا على قواعد جديدة للعبة وعقلا سياسيا جمعيا يرتب الأولويات بشكل صحيح.
تطمح هذه الورقة إلى مساعدة القوى المناهضة للانقلاب والمؤمنة بضرورة استئناف مسار الانتقال الديمقراطي على بناء “سردية جديدة” للاجتماع السياسي الوطني، تساعد على تحقيق الهدفين الأساسيين المعلنين، أي كسر الانقلاب وهزيمته، و الحيلولة دون تكرار الأخطاء الكبرى المسجلة خلال العشرية الأولى مع توافق أغلبي على أسس مشروع حضاري وطني جديد يحقق الديمقراطية والتنمية معا.
-1 الثورة والانتقال الديمقراطي:
 لعل واحدة من أهم المعضلات الكبرى التي واجتها الأطراف المعنية بالشأن الوطني ابتداء من 14 جانفي/يناير 2011، هي الاختلاط المفاهيمي واللبس الناتج عن الخلط بين مقاربتي “الثورة” و”الانتقال الديمقراطي”، أو بين المسارين “الثوري” و”الانتقالي”، وهو الخلط الذي سيتسبب في إرباكات كثيرة وأخطاء متعددة على مدار العشرية، على نحو يدفع بعضهم إلى ترتيب أحكام من منطلق “ثوري” على موضوع يتعلق ب”الانتقال الديمقراطي” أو العكس حيث تصدر أحكام من منظور ديمقراطي على قضايا وإشكاليات ثورية بامتياز.
لعل واحدة من أهم المعضلات الكبرى التي واجتها الأطراف المعنية بالشأن الوطني ابتداء من 14 جانفي/يناير 2011، هي الاختلاط المفاهيمي واللبس الناتج عن الخلط بين مقاربتي “الثورة” و”الانتقال الديمقراطي”، أو بين المسارين “الثوري” و”الانتقالي”، وهو الخلط الذي سيتسبب في إرباكات كثيرة وأخطاء متعددة على مدار العشرية، على نحو يدفع بعضهم إلى ترتيب أحكام من منطلق “ثوري” على موضوع يتعلق ب”الانتقال الديمقراطي” أو العكس حيث تصدر أحكام من منظور ديمقراطي على قضايا وإشكاليات ثورية بامتياز.
ومما يجدر الانتباه إليه والتوقف عنده مليا، أن الانقسام الفكري والسياسي انطلق منذ اللحظات الأولى لسقوط نظام الرئيس بن علي، بين من يرى في الأمر ثورة مكتملة الأركان، وبين من يرها جيلا جديدا من الثورات اتسمت بها حقبة ما بعد سقوط جدار برلين وانهيار المنظومة الشيوعية وسطوع فجر القرن الحادي والعشرين، ومن يعتقد أنها انتفاضة أو هبة شعبية بلا برنامج محدد أو قيادة واضحة، وقد شكل هذا التباين في التشخصين مدخلا لانقسامات أخرى فرعية ومزايدات سياسية لم تنقطع إلى اليوم وتوجهات مختلفة لم يتمكن أصحابها من التوافق على أرضية مشتركة صلبة تتطلبها الحوكمة الجيدة للمسار المترتب عن الظاهرة أيا كان توصيفها أو تسميتها.
وبهذا الصدد من الأهمية بمكان بيان بعض الفوارق الأساسية بين المقاربتين، أي “الثورة” و”الانتقال الديمقراطي”، فالثورة مسار عميق يتجاوز السياسي إلى الحضاري، أما الانتقال الديمقراطي فهو “آلية للتغيير السياسي” هدفها الاستعاضة عن نظام استبدادي أو تسلطي فردي بآخر ديمقراطي وتعددي، ولئن كانت الثورة معطا تاريخيا قديما، إذ الثورات مجال قرون من الزمان، فإن الانتقال الديمقراطي آلية تغيير معاصرة جاءت جراء خبرات تبلورت تدريجيا ابتداء من ثمانينيات القرن الماضي واكتملت شروطها ومحدداتها في مطلع القرن الحالي، وهي نتاج مقاربات عمل على تطويرها المجتمع المدني العالمي من خلال تجاربه المتعددة في مختلف أنحاء العالم، وساعدته عليه نخب الفكر العالمي الجديد بالدرجة الأولى.
ولئن كان المسار الثوري مسارا مفتوحا في الزمان، قد يقتضي التمكين له قرونا، باعتباره مسارا أعمق من مجرد تغيير سياسي، يطال المفاهيم والوسائل والمصالح، فإن مسار الانتقال الديمقراطي يفترض به أن يكون محدودا من الناحية الزمنية، ولكنه في كل الأحوال يقتضي عقودا أيضا، وإذا كانت الثورة ترنو إلى انتصار الجديد على القديم باعتبارها قطيعة بالمعنى الشامل، فإن الانتقال الديمقراطي يقوم على توافق “الجديد” مع “القديم”، وتعاون “الجديد” مع “القديم”، وتشارك “الجديد” مع “القديم”، في بناء النظام السياسي الديمقراطي التعددي المنشود، ومن مظاهر الخلط هنا ذلك الانطباع السائد بأن مشروع “الانتقال الديمقراطي” هو مسؤولية ما يمكن تسميته ب”المنظومة الجديدة” التي ترمز إلى الثورة في مواجهة “منظومة قديمة” تمثل “الثورة المضادة”، ففي جنوب أفريقيا مثلا تعاون مانديلا والمؤتمر الأفريقي مع ديكليرك وحزبه الأبيض لتفكيك نظام الأبارتهايد وإقامة النظام الديمقراطي، وفي تشيلي تعاونت القوى الديمقراطية مع نظام الديكتاتور بيونيشيه لدمقراطة النظام السياسي في سنتياغو، وفي أوربا الشرقية والوسطى تعاونت الأحزاب الشيوعية التي تحولت إلى “ديمقراطية اشتراكية” مع قوى التغيير المدني والديمقراطي لانجاح مسارات الانتقال نحو أنظمة ديمقراطية، وهو ما تحقق أيضا في اليابان بعد الحرب العالمية الثانية وفي كوريا الجنوبية وسائر النمور الآسيوية منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وعند أي حديث عن الانتقال الديمقراطي لا بد من التوقف عند أربعة مضامين أساسية هي بمثابة الشروط التي يجب الالتزام بتحقيقها لكي تستجيب آلية التغيير السياسي المعتمدة لهذا التوصيف: – أولا: الانتقال السلمي للسلطة والتداول اللاحق عليها، فالمدنية والسلمية ميزتان رئيسيتان ليس بالمقدور الاستغناء عنها، ولهذا فقد كان “الطابع اللاعنفي” هو الغالب في سيرة جل التجارب والخبرات في هذا المجال، خلافا لما كان معروفا في سير آليات التغيير الأخرى من قبيل الثورات الكلاسيكية والانقلابات العسكرية.
-ثانيا: العدالة الانتقالية، التي تتضمن بدورها ثلاثة شروط هي الحقيقة (يسميها بعضهم المحاسبة أو يعتبرها وسيلة لتحقيقها) والإنصاف أو جبر الضرر والمصالحة الوطنية الشاملة.
-ثالثا: النظام الديمقراطي القائم على التعددية الفكرية والسياسية والضامن للحريات وحقوق الإنسان والتمكين لمبدأ السيادة الشعبية على قاعدة الانتخابات النزيهة والشفافة، وليس هناك صيغة واحدة لهذا النظام أو شكل موحد، فكل بلد مطالب بتفصيل النظام الذي يناسبه مع احترام الضوابط المذكورة.
رابعا: التنمية الشاملة والمستدامة، فكل ديمقراطية لا تنتج تنمية تطال جميع مواطنيها ومناطقها ولا تحترم البيئة وتحفظ حقوق الأجيال القادمة، هي ديمقراطية منقوصة وعرجاء وغير مقنعة.
وتجدر الإشارة أخيرا، إلى ضرورة إيلاء الخصوصيات الثقافية والسياقات التاريخية وخصائص الشخصية الوطنية الأهمية التي تستحق، حتى يتجنب كل إسقاط مفاهيمي وتعسف ايديولوجي، في تحليل العلاقة بين المسارين الثوري والانتقالي، فلكل قاعدة استثناء، كما يحق للشعوب أن تنحت معالم تجاربها التاريخية الخاصة.
– 2 سرديات العمل السياسي خلال العشرية:
 خلال عشرية الانتقال الديمقراطية، من 14 جانفي 2011 إلى غاية 25 جويلية 2021، تبلورت العديد من “السرديات” أو “الروايات الفكرية والسياسية” التي كانت مسؤولة إلى حد كبير عن إنتاج جملة من السلوكيات والمواقف والظواهر والسير السياسية والحزبية، وكانت كذلك سببا في جل المشاكل والإخفاقات والإرباكات التي هددت بوقف المسار في أكثر من لحظة فارقة، وانتهت بالمعنى “التراكمي” إلى التمهيد لهذا الانقلاب الذي ارتبط بدوره بإحدى هذه السرديات، وكان دالا على تهافتها جميعا، بما في ذلك سرديته، وهو ما يمكن إيجازه كما يلي:
خلال عشرية الانتقال الديمقراطية، من 14 جانفي 2011 إلى غاية 25 جويلية 2021، تبلورت العديد من “السرديات” أو “الروايات الفكرية والسياسية” التي كانت مسؤولة إلى حد كبير عن إنتاج جملة من السلوكيات والمواقف والظواهر والسير السياسية والحزبية، وكانت كذلك سببا في جل المشاكل والإخفاقات والإرباكات التي هددت بوقف المسار في أكثر من لحظة فارقة، وانتهت بالمعنى “التراكمي” إلى التمهيد لهذا الانقلاب الذي ارتبط بدوره بإحدى هذه السرديات، وكان دالا على تهافتها جميعا، بما في ذلك سرديته، وهو ما يمكن إيجازه كما يلي:
- أولا: سردية الثورة: وهي التي تنطلق من أن الانتفاضة الشعبية التي استجدت بين 17 ديسمبر 2010 و14 جانفي 2011، هي ثورة حقيقية مكتملة الأركان وإن افتقدت إلى قيادة وبرنامج محدد ومرجعية ايديولوجية معينة، وهي ثورة الحرية والكرامة، مضمونها يعبر عنه شعار “شغل، حرية، كرامة وطنية”، وأن هذه الثورة قد جعلت النخب نوعين: “ثورة” تعبر عنها القوى السياسية الجديدة ممثلة في غالبيتها في الأحزاب والتيارات المعارضة للنظام السابق بزمنيه البورقيبي والنوفمبري، و”ثورة مضادة” تتمثل في ما يسمى ب”المنظومة القديمة” التي تدور في فلك الحزب الحاكم السابق وتوابعه، وأن مسار الانتقال الديمقراطي ليس سوى مناط صراع بين المنظومتين الجديدة والقديمة، وأنه أطوار متقلبة ومراحل متعددة بين الطرفين المتصارعين، مع اعتماد كل منهما على مساندين وداعمين في المحيطين الاقليمي والدولي. ولكن الانقلاب أثبت التهافت النسبي لهذه السردية، حيث ناصر الكثير ممن كانوا يحسبون على المنظومة الجديدة أو على التيار الثوري الانقلاب، بل لعل بعض كان داعيا له ومنظرا لحصوله ومدافعا عن منفذه الذي كان بدوره يعتبر نفسه “أحد كبار الثوار” إن لم يكن “الثائر الصادق الوحيد”، وبالمقابل أظهرت العديد من الشخصيات المحسوبة على “المنظومة القديمة” اعتراضها الشديد على الانقلاب وتمسكها بالمسار الانتقالي الديمقراطي وانخراطها في مبادرات مناهضته والعمل على إيقافه والتعاون مع الآخرين من أجل إبطال مفعوله في أسرع وقت.
- ثانيا: سردية الدولة: وهي تلك التي تبنتها “الحركة الفاشية” التي صورت الثورة باعتبارها مؤامرة خارجية على الدولة الوطنية التونسية، برعاية “أمريكية غربية” وتنفيذ من “الحركة الإسلامية وتوابعها”، وهو ما يجعل المشهد منقسما بين “الوطنيين” و”الخونة”، وأن الصراع يقتضي تكتل هؤلاء الوطنيين في جبهة متماسكة بقيادة فردية خالصة لإنقاذ الدولة والوطن وتفكيك المؤامرة واستعادة تونس ممن اختطفها. وقد كشف الانقلاب على مسار الانتقال الديمقراطي أيضا مدى هشاشة وهزال هذه السردية، حيث بدا المشروع السياسي المرتبط بها مجرد آلية تتداخل في تحريكها أطراف داخلية وخارجية، تتناقض مصالحها مع نجاح التجربة الديمقراطية الواعدة، وقد وجدت في “الفاشية” التي تزعم الانتصار للوطن والدولة عصبية صالحة لإضعافهما معا.
- ثالثا: سردية الفساد: وهي تلك التي تتبناها “النزعة الطهورية” التي صورت الواقع بعد الثورة باعتباره مجالا للصراع بين “الفاسدين” و”الطاهرين”، وأن “الفساد” ظاهرة سياسية واقتصادية واجتماعية بلغت مداها، على نحو تجد أثرا له تحت كل حجر وعند كل زاوية، وفي مجتمع “ريعي” يميل إلى الكسب السهل وتراجعت بين أبنائه قيمة “العمل” والسعي إلى خلق “الثروة”، وفي سياق فرضت فيه أجندات خارجية عبر مجتمع مدني وظيفي هش إسقاطات مستوردة، وجد خطاب مكافحة الفساد والفاسدين هوى في نفوس المواطنين، وهو ما ساعد على ترتيب الأولويات السياسية الوطنية على نحو خاطئ، حتى اضطرت جل القوى السياسية، بما في ذلك الوسطية والمعتدلة، إلى مجاراة الخطاب الطهوري ، وأوقع البلاد في شرور كبيرة، برزت خاصة في نتائج الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019، التي كانت مقدمة للانقلاب. ولكل متفحص في الأرقام، سيجد أن الفساد وإن كان معضلة فعلا، فهو لا يجب أن يتقدم على أولويات أخرى ذات أهمية أكبر في ضمان تدفق الديمقراطية والتنمية معا، ذلك أن تونس مثلا هي البلد الأقل فسادا في المنطقة المغاربية، وواحدة من أفضل الدول العربية ترتيبا في مجال مكافحة هذه الظاهرة.
- رابعا: سردية الانقلاب: وهي سردية مزيج من السرديات الآنفة الماضية، فصاحب الانقلاب لطالما ادعى أنه يمثل الرؤية الثورية النقية، في مقابل مخططات أهل الثورة المضادة ممن أحلوا 14 جانفي مكان 17 ديسمبر، وصادروا المشروع الثوري الحقيقي الممثل في شعار “الشعب يريد”، فضلا عن كونه الرجل الذي يقود الحرب ضد أعداء الدولة والمتآمرين عليها ممن عملوا على اختطافها من الداخل وتخريب مؤسساتها..إلخ، إلى جانب زعمه أنه “أطهر الطاهرين” وأن مشروعه استعادة أموال الشعب المنهوبة وإعادتها إليه..ألخ. وقد تبين من خلال الانقلاب وما يليه، أن الأمر لا يتجاوز هلوسات وشقشقة لفظية وأوهام غير قابلة للتنفيذ ومجرد دعاية شعبوية رثة.
إن حقيقة مسار الانتقال الديمقراطي تقع في رأيي خارج دوائر هذه السرديات المتهافتة.
3- ملامح سردية جديدة
كانت الثورة التونسية حدثا مفاجئا للنخب، خصوصا نخب المجالات الثلاثة المعنية بإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي، أي الأحزاب السياسية ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، ففي مستوى الأحزاب السياسية التي يفترض أن تكون ضمان جودة التوافقات والانتخابات وسائر المؤسسات الضرورية، كانت أقرب إلى “مشاريع أحزاب” منها إلى أحزاب حقيقية قادرة على صناعة القادة وتأطير الكفاءات وبناء برامج التنمية والتزام القواعد الأخلاقية في تسيير الحياة السياسية، وفي مستوى وسائل الإعلام هيمنت “الإثارة” على “الحقيقة” و”الابتذال” على “الجدية” وكانت هذه النوعية من الوسائل الإعلامية أحد أهم أسباب ترذيل المشروع الديمقراطي والعمل السياسي، أما في مستوى منظمات المجتمع المدني فقد طغت “الوظيفية” على “النضالية” و”التبعية” على “الاستقلالية” ممن دفع إلى انخراط عدد من أهم هذه المنظمات في اسقاط هذه التجربة الديمقراطية الواعدة بوعي منها أو دون وعي، فيما هي أكبر المستفيدين منها.
لكن في قالب كل “محنة” “منحة” كما يقول المثل العربي، فلأول مرة في تاريخ الدولة الوطنية التونسية المستقلة، يشهد الاجتماع السياسي انقاسا على قاعدة “الديمقراطية”، حيث يحدث الفرز بين القوى السياسية والمدنية على أساس “الموقف من الانقلاب”، وتظهر ميادين النضال الميداني هذا الفرز بين المتشبثين بالخيار الديمقراطية وشرعية المؤسسات المنتخبة ودستور الجمهورية الثانية لسنة 2014، وبين المساندين للانقلاب والمسايرين له والمستعدين للمساومة على النظام الديمقراطي وقبول نظام سياسي استبدادي أو تسلطي فردي أو هجين من جديد.
وتدفع سياقات ما بعد الانقلاب السياسية والفكرية والحزبية والمدنية وغيرها، إلى إبراز ملامح سردية جديدة، يمكن تسميتها ب”السردية الديمقراطية” الجامعة والمعبئة لأكبر قدر من القوى المدنية والسياسية المؤمنة بما يلي:
- مناهضة الانقلاب باعتباره جريمة في حق الوطن والدولة والنظام الديمقراطي، وخيانة لدماء الشهداء عبر جميع معارك تونس الكبرى وثوراتها خالدة من أجل الحرية والاستقلال والعدالة وحقوق الانسان، فضلا عن كونه ضربا فاضحا وصارخا للمنظومة الأخلاقية ومصالح البلاد العليا وسمعتها الدولية واشعاعها الحضاري.
- إن الديمقراطية فضلا عن كونها ضرورة دستورية وقانونية وسياسية، فهي ضرورة تنموية إذ قد تحقق بقية الانظمة تنمية ما، لكن النظام الديمقراطي وحده القادر على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة ومقنعة تجمع بين الحرية والكرامة.
- إن استدامة الديمقراطية تقتضي ناهيك عن النضال السياسي المخلص والمستمر ثورة ثقافية وفكرية وحضارية لا بد وأن تعمل الدولة على توفير مقومات انجازها، بالشراكة مع المجتمع المدني وسائر المؤسسات المعنية، خصوصا منها التربوية والإعلامية.
- لقد بينت الأزمة أن معركة الديمقراطية لا يمكن أن تكون معركة وطنية فحسب، إذ على الديمقراطيين التونسيين خوضها بأفق إقليمي ودولي، حيث بينت وقائع الانقلاب أن انكفاء تونس الديمقراطية على نفسها شجع قوى الاستبداد في المنطقة على النيل منها، ومن هنا ضرورة أن تكون تونس قلعة تبشير بالديمقراطية وقاعدة للحركة الديمقراطية والمدنية في العالم العربي خاصة، وبقية الدوائر المعنية عامة، وأن ترسم سياستها الخارجية وخططها الديبلوماسية ضمن هذا الأفق.
- وأخيرا، فقد تبين أن المعركة من أجل الديمقراطية هي جزء من معركة أكبر هي معركة “استكمال الاستقلال” وأن القوى الاستعمارية ما تزال تمانع في تحول مستعمراتها السابقة إلى النظام الديمقراطي، وأنها متمسكة ب”نظام الوكيل” الحارس لمصالحها، وهو ما يمنح المعركة بعدا وطنيا وحضاريا أعمق.