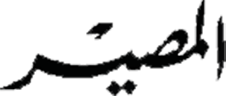خالد شوكات: أمّةُ القرآن


بقلم: خالد شوكات
قال تعالى:”إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونْ”
(الحجر – 9)
في زيارتي الأخيرة إلى تايوان التقيت الشاعرة العراقية الكبيرة أمل الجبوري، وهي شخصية أدبية عربية مرموقة من رفاق أدونيس ومحمود درويش وعبد العزيز المقالح وغيرهم من كبار شعراء الأمة، وقد حملت لواء الشعر العربي النسوي مذ كانت طالبة في بغداد أواخر ثمانينيات القرن الماضي، وهي سليلة إحدى أكبر العشائر العربية العراقية، وكانت في مرجعيتها الفكرية علمانية متشدّدة، إلّا أنها كما أخبرتني قامت بمراجعات جعلتها خلال السنوات الأخيرة أكثر قربا من التصّوف والعرفان، وقد فاجأتني حين كشفت لي عن تخطيطها لبيع منزلها في لندن والتبرّع بثمنه أو جزء منه لمدارس تحفيظ القرآن الكريم في المغرب أو موريتانيا..
وللقرآن منذ أنزله الله على نبيّه الخاتم محمد بن عبد الله صلّى الله عليه وسلّم، أسرار في الإنسان والزمان والمكان، ولكلّ مؤمن قصّة مع هذا الكتاب المقدّس المعجزة الذي يختلف عن جميع الكتب المقدّسة الأخرى، فهو النص المحفوظ الذي يخترق التاريخ منذ خمسة عشرة قرنا، لم يطرأ على متنه أي تغيير، فيما يفيض بأنواره على الكون تفسيرا وتأويلا، عابرا ظروف البشر والبلدان والأقوام والأمم المتقلّبة المتغيّرة، لسانه العربي المبين هو اليوم الأعرق بين جميع الألسنة المحكية، قاهرا جميع المتآمرين عليه والطاعنين فيه، فقد ذهبوا وبقي هو صامدا فاعلا محيّرا ومعجزا وملهما، تلهج به الأفئدة وتستنجد به القلوب الحائرة بحثا عن الطمأنينة.
ولي مع القرآن شخصيا حكايات كثيرة تستحقّ الرواية ويضيق بها المقام، من بينها إنّني مدين له بهذه اللغة العربية التي بها أفكّر وأكتب وأخطب وأتكلّم منذ عقود، وكان بعض الأصدقاء من المشرق يسألونني من باب التقدير والإعجاب أحيانا عن السر فأقول دون تردّد إنها التربية على القرآن التي تقوّم اللسان، فإن أردتم تقويم ألسنة أبنائكم وتمكينهم من لغتهم الأم فربّوهم على القرآن، ذلك إنني محظوظ بنشأتي في أسرة صلتها قوّية بالكتاب، فقد أدّبني إمام قريتي “المدّب الصويعي” رحمه الله وجزاه عنّي كل خير بتحفيظي أجزاء من القرآن، في مسجد القرية الصغير، وكان والدي أطال الله في أنفاسه ما يزال يحفظ القرآن ويرتّله آناء الليل وأطراف النهار وقد جاوز اليوم الثمانين من عمره، وهو يدين أيضا للكتاب الذي أنقذه من الأمية التي أصابت غالبية أبناء جيله من سكّان الأرياف النائية، وكان عمّه جدّي مهذب رحمه الله حافظا لكتاب الله من خرّيجي فروع الزيتونة المعمور، وقد أخبرني والدي بأن “سرّ الشوكات” أهلي في القرآن، فقد كان من بينهم على قلّة عددهم ستّة أو سبعة يحفظون الكتاب ويقرأون للنّاس رسائلهم ويكتبون لهم شكاويهم أيّام كان القرّاء يعدّون على الأصابع ويفزع إليهم الناس طلبا للعون والدعاء.
وقد تعرّفت عندما كبرتُ وجلتُ في هذه الدنيا الفانية، أصدقاء من أهل الكتاب، من بينهم مسيحيون أخبروني بمواظبتهم على سماع القرآن يوميا والاستمتاع بتلاوته بحناجر كبار المقرئين كعبد الباسط عبد الصمد رضي الله عنه، وأنهم بدورهم يدينون بلغتهم له وإن لم يدينوا بدينه، ويعتبرون أنفسهم مساهمين في بناء الحضارة العربية الإسلامية إلى جانب إخوانهم من المسلمين.
ويذكر الكاتب سامي الجندي في كتابه الذي خصصّه لسيرة الزعيم الوطني التونسي الشيخ عبد العزيز الثعالبي، من مناقب هذا الرائد النهضوي الكبير “إنّه كان أخطب خطباء الأمّة في زمانه، وأن الأمر مرّده التكوين القرآني للشيخ، فهو من علماء الزيتونة المجدّدين ومن أعلام الأمّة المصلحين”.
وفي سيرة الزعماء والقادة التونسيين، خصوصا منهم روّاد الحركة الإصلاحية والوطنية، لا ريب في أنهم جميعا مدينون للقرآن في الكتابة والخطابة وطلاقة اللسان، ومن الحكايات التي تعلق في الذهن ضمن هذا السياق، إنني لمّا التقيت الرئيس الباجي قائد السبسي سنة 2012 لأوّل مرّة، وهو يدعوني للالتحاق بقيادة حركة نداء تونس، سألني عمّا اعتقد بأنه سبب دعوته لي، فقلت “لا أعلم”، فقال لي “لقد دعوتك حتى تعينني على قلم الإسلام”، وحدّثني بالمناسبة عن قصّته مع كتاب الله إذ قال رحمه الله “أن حفظ ربع القرآن كان شرط والدته عليه رحمها الله حتّى تأذن له للالتحاق بالمدرسة الصادقية، إذ كانت تخشى على تربيته من النزعة الافرنجية لهذه المدرسة، فأرادت تحصينه بأجزاء من كتاب الله، وهو ما جعل الآيات تجري على لسانه في خطبه ضرباً للأمثال”، وكان في ذلك مضربا للمثل عند معاصريه وعموم الجمهور من الناس، وسرّ “قبوله” لدى غالبية التونسيين الذين جبلوا على حبّ القرآن وحبّ الإسلام، كيف لا و اسم بلادهم قد اقترن بالزيتونة المباركة وجامعها المعمور وجامعتها المنارة التي أفاضت بعلوم القرآن شرقا وغربا، والزيتونة في الأصل عبارة قرآنية وزيتها الضياء الذي يفيض على الدنيا بأنواره الربّانية، وكذلك أفاضت على غربها فكان جامع القرويين الذي يفخر اليوم بحفظه لكتاب الله في مغرب الأمّة، وأفاضت شرقا فكان الجامع الأزهر الذي بلغ صيته المدى وعلماؤه يحفظون القرآن في أفريقيا وآسيا وأرجاء الدنيا قاطبة.
وقد عدت قبل أيام من المغرب الشقيق، التي تعتبر اليوم من أكثر البلاد الإسلامية تعدادا للمدارس والمعاهد القرآنية، حيث أخبرني أحد الإخوة عن دور هذه المدارس والمعاهد التي يؤمّها عشرات الآلاف من طلبة العلوم الإسلامية وحفظة الكتاب الكريم، في تحصين الأمّة من الإرهاب، فالأمم التي تحفّظ أبناءها القرآن هي الأكثر تحصينا وتلقيحا إزاء ظاهرة التطرّف الديني والفكر العنيف خلافا لما يروّج بعض “المتفيقهين” خصوصا في بلادنا، ممّن قلّ علمهم وكَثُرَ هرجهم، والهرج أي كثرة الكلام بلا فائدة هو صفة من صفات قليلي العلم ممّن قد يخدعون بعض أنصاف المتعلّمين بالشقشقة اللفظية والطعن في القرآن ولكنّ حقيقتهم هي المحدودية والشقاء الروحي جرّاء الغرور العقلي.
وعلى مرّ تاريخ القرآن، شهد الكتاب العزيز الكثير من الطاعنين والطعون، سواء من داخل الأمّة كالمعتزلة مثلا بحجّة العقل، ومن خارجها كالمستشرقين على سبيل المثال بحّجة العلم، ولكن جميع هؤلاء قد مضوا وبقي القرآن الكريم صامدا ماضيا في أداء رسالته تجاه المؤمنين به خاصّة وتجاه الإنسانية عامّة، وهي التي تحتاجه كلّ يوم أكثر وستحتاجه أكثر في قادم الأيام، وهو كتاب بيان وبرهان وعرفان كما قال العلماء، يسحر الألباب ويقوّم اللسان ويملأ الروح بحبّ بارئها وبحبّ خاتم الأنبياء والمرسلين، ويربّي البشر على الرحمة والخلق القويم، وليعلم القوم ممّن جهلوا قيمته وأنكروا فضله وظلموا أهله أنّهم لن يعجزوا من أنزله الذي وعد بحفظه، وحفظه آية من آيات إعجازه لو يتدبّرون.